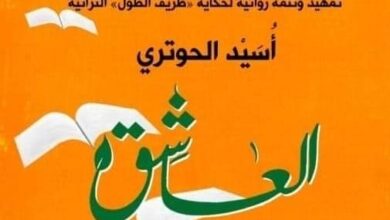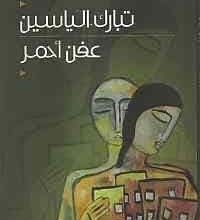التجويع كسلاح: من غزة إلى صفحات التاريخ
صفاء الحطاب
في ظل الأحداث المتواصلة التي تعصف بقطاع غزة، بات التجويع سلاحًا ممنهجًا يستخدمه العدو الإسرائيلي في محاولة لإخضاع شعب لم ينكسر، ولإذلال أمة ما تزال تنبض بالحياة رغم الجراح. إن حرمان أكثر من مليوني إنسان من الغذاء والماء والدواء، ومنع دخول المساعدات، وتحويل رغيف الخبز إلى حلم مؤجل، ليس حدثًا عابرًا، بل امتداد لجريمة مركبة تُمارس أمام أعين العالم بصمت مخز وتواطؤ سافر.
لكن ما يحدث في غزة ليس بدعة جديدة في سجل الإنسانية الجريح؛ بل هو فصل مكرر من تاريخٍ عرف التجويع كسلاح سياسي وعسكري في وجه الشعوب المقاومة.
نعود إلى حصار لينينغراد خلال الحرب العالمية الثانية، حين حاصرت القوات النازية المدينة الروسية لما يزيد عن 872 يومًا، مستخدمة الجوع كوسيلة لإخضاع السكان. مات أكثر من مليون شخص جوعًا، لكن المدينة لم تستسلم.
كما لا يمكن تجاهل حصار غرناطة في الأندلس عام 1491، حين استخدمت الملكة إيزابيلا وزوجها فرناندو سلاح التجويع لخنق المدينة المسلمة الأخيرة في إسبانيا. استمر الحصار شهورًا طويلة، أُغلقت فيها سبل النجاة، ونفدت المؤن، وقاوم أهل المدينة حتى الرمق الأخير قبل أن يُجبروا على الاستسلام تحت شروط مذلة، فتُوّج بذلك سقوط الأندلس، وأُعلن انتهاء قرون من الحضارة الإسلامية فيها.
أما في العصر الحديث، فنتذكر حصار سراييفو في تسعينيات القرن الماضي، حين عاش المدنيون تحت قصف وجوع وعطش دام لأكثر من ثلاث سنوات، دون كهرباء أو دواء أو أمل قريب.
لكن في غزة، تتجلى المأساة بأشد صورها؛إنها مجزرة جوع لا تُنفّذ فقط بالسلاح، بل بالقرار. تُمنع شحنات الطعام، تُقصف الأفران، تُستهدف الطوابير الباحثة عن كسرة خبز، يُخنق البحر وتُحاصر البراري ويُقصف حتى الهواء حين يختنق بالغازات. والغاية واحدة: إذلال الفلسطينيين حتى يتخلوا عن ثوابتهم، عن أرضهم، عن حلم العودة، عن مقاومة الاحتلال.
ورغم ذلك، تجدهم – جائعين – يرفضون الخضوع. يموت الأطفال على أرصفة الانتظار، لكن الجدران لم تُرفع بعد للرايات البيضاء. يُذبحون ببطء، لكن دون أن ينحنوا. يتناقص الطعام، لكن لا تتناقص كرامتهم.
في هذا السياق، يتكشف زيف المعايير التي صيغت بعد الحرب العالمية الثانية باسم “العدالة” و”الكرامة الإنسانية”، ويتهاوى البناء الأخلاقي الذي شُيّد فوق ركام الحروب والاستعمار، بعدما ادّعى قادة العالم أنهم تعلموا من المآسي وأنشؤوا مؤسسات لحماية الإنسان من الظلم والطغيان. لكن ما نشهده اليوم، من صمت على المجازر وتواطؤ مع القمع واستباحة شعوب بأكملها، يكشف عن زوال فعلي لتلك القيم، وانهيار فاضح لمنظومة حقوق الإنسان. لقد تحوّلت القوانين الدولية إلى أدوات انتقائية تُفصّل حسب مصالح الأقوياء، وأُعيد إنتاج الاستعمار بأقنعة ناعمة، تُدار من غرف السياسة والإعلام والاقتصاد. لم يعد الاستعمار يهبط بالمظلات، بل يحاصر الشعوب بالديون، ويخنقها بالحصار، ويبرر الفتك بها تحت شعار “الحرب على الإرهاب”. وهكذا، تهاوت منظومة القيم التي رفعتها الإنسانية بعد الحرب، وتحولت من درع للضعفاء إلى درع لهيمنة الأقوياء.
في ميدان الأخلاق والقيم، تقف غزة صامدة في وجه عالمٍ تتهاوى فيه المبادئ عند أول اختبار. إنهم لا يطالبون بالترف، بل بحقوقهم الأساسية؛ لا يرفعون شعار الغنيمة، بل عنوان الحياة. ومع ذلك، يُقابلون بالخذلان، ويُستقبل موتهم بصمت، كأن الكرامة لا تستحق الدفاع عنها إذا كانت لفلسطيني.
وما أشد الحسرة حين يموت الإنسان جوعًا، لا لندرة الغذاء، بل لمنعه عنه عمدًا. وما أعظم المأساة حين يُترك شعبٌ كامل بين فكيّ الحصار، لا لذنب سوى أنه قرر أن لا يساوم على أرضه، ولا يهادن في حقه.
ختاما
غزة اليوم، كما لينينغراد، وغرناطة، وسراييفو، تكتب صفحة دامية في سجل الإنسانية، لكنها تترك بصمتها الأخلاقية ناصعة، شاهدة على أن الجوع قد يفتك بالجسد، لكنه لا يطعن الروح الحرة. وإن سقطوا شهداء وهم يبحثون عن الرغيف، فقد ارتقوا وهم متمسكون بالحق، وبالكرامة، وبالهوية.
وإن كان العالم قد خذلهم، فإن التاريخ سينحني لهم احترامًا، لأنهم – ببساطة – جاعوا بكرامة، وماتوا دون أن ينحنوا.
لكن بالمقابل، فإن هذا الصمت العالمي، وهذه الشراكة غير المعلنة في الجريمة، ستظل وصمة عار أبدية في جبين الإنسانية.
سيكتب التاريخ، كما كتب عن مذابح ومحارق وجرائم صمت عنها العالم يومًا، أن غزة جُوّعت عمدًا، وتُرك أطفالها يموتون جوعًا، بينما كانت المنظمات “الإنسانية” منشغلة بالإدانة المتوازنة، والحكومات تتهرب من قول كلمة حق.
وستبقى هذه الوصمة سوداء لا تمحوها الأعذار، ولا تبررها الحسابات السياسية، ولا يغسلها الزمن!
Views: 22